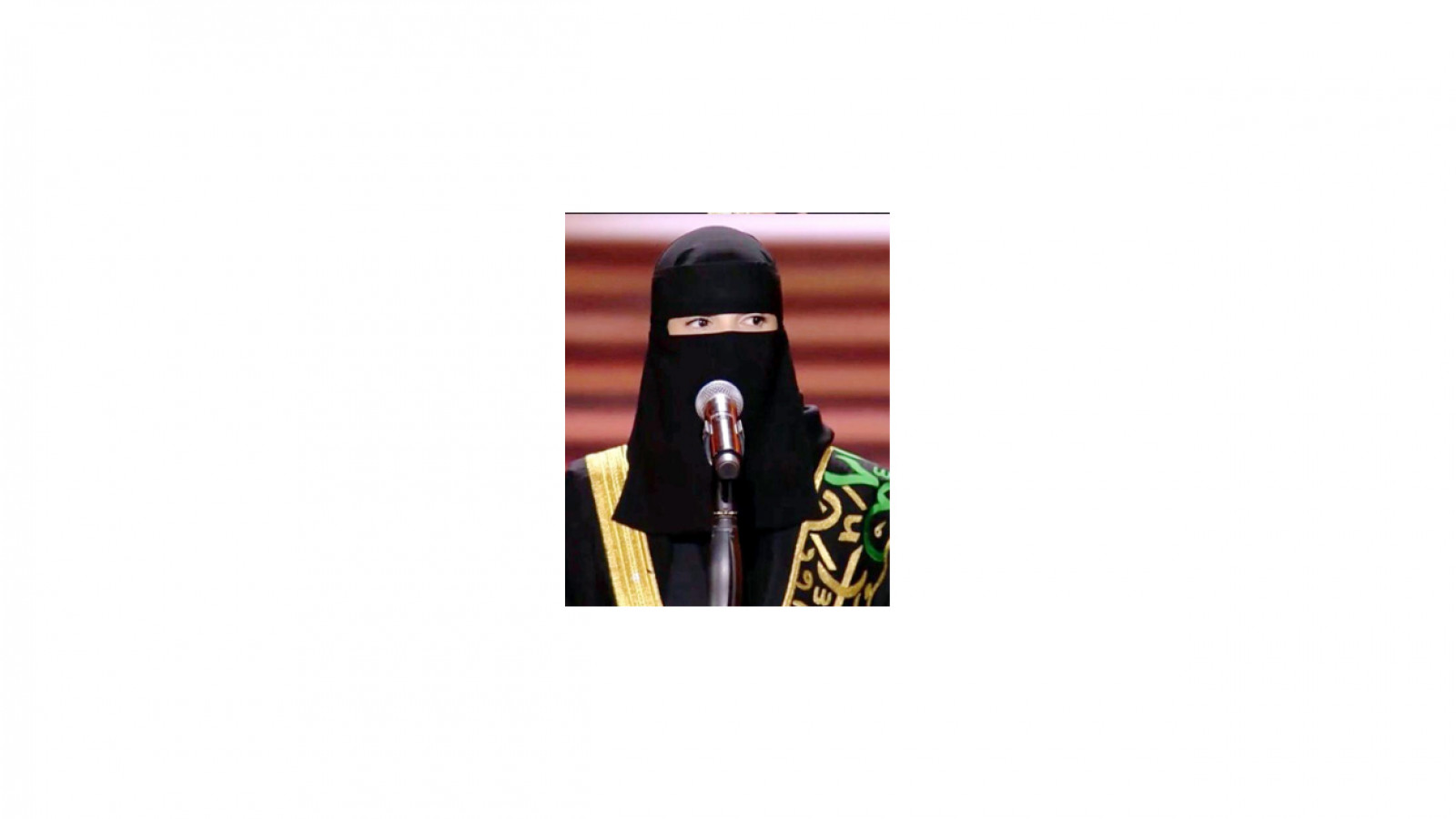
-عتبة العنوان وميلاد الرؤية (حزنائيل)عنــــوانٌ لافـــــتٌ منذُ الوهلة الأولى، إذ يجمعُ بين مُفردتين تحملان ثِقلًا دلاليًّا وروحيًّا عميقًا: (حُزن، وإيل) فـ»الحزن» هو الحالة الشعورية العميقة والناتجة عن الألم، لكنّهُ ليس حُزنًا عابرًا بل جاء مُقدّسًا حين ارتبط بـ«إيل»، الذي يُطلق في الموروث السامي على الإله أو القوة العُليا الخالقة. وعندما تدمج (الدبيس) بين المفردتين في حزنائيل، فإنّها تخلق كيانًا رمزيًّا فريدًا، كأنها تُقدِّس الحُزن ذاته، وتجعل منهُ كائنًا نورانيًّا يتطهَّر في حضرة الإله. أظهرتْ الشاعرة ذكاءً إبداعيًّا في اختيار هذا العنوان الذي يتجاوز حدود المفردة إلى أُفُقٍ أسطوريٍّ وروحيٍّ رحِب. في اثنين وثلاثين وحيًا تنثـــرُ الشاعــــرة وهجَهــــا في مزيجٍ فريدٍ يجمع بين الشعر العمودي، والتفعيلة، والكتابة النثرية، والقصة، في تمرُّدٍ جميلٍ ذكي لا يُشبه سواه، ويضمُّ الكتاب في طيّاتهِ تسلسُلًا زمنيًّا بقالب كرونولوجي يفيضُ من لحظة العلَقِ الحائر إلى لحظة تحرر الروح من سجن الجسد، في رحلة وجدانيّة تُحاكي سرّ الوجود وتقلُّباتِ الشاعرة في عوالمها الخاصة بين البدء والفناء. بلُغةٍ شاعرية، فلسفية، وروحيّة عميقة، مليئة بالتساؤلات وأنسنة اللحظة في توظيف شعري ووجدانيٍّ صافٍ وعميق. -قدسيّة اللغة وعمق الأسلوب أمّا اللغة في حزنائيل فهي لغة فلسفيّة، وروحيَّة عميقة، مليئة بالتساؤلات،وذات قُدســـيّــــة مهيبـــــــــة، وبُعــــد سمـــاويٍّ، تنساب كوحي مُنزل، أو تراتيل صلاة، أو سكون مناجاة، تتحوّل فيها المفردات كالوجع، والحب، والكتابة، إلى لحظات خالدة في النصوص، وحين تبلغ اللغة هذا المقام القدسي، يتجلّى الأسلوب الشعري في طاقته الروحيَّة التي تمزج بين البشري والإلهي في بُعدٍ تأمُّليٍّ يتجاوز المعنى الظاهر، لتلامس العمق الكوني للوجود وأثر انعكاسه في ذاتها حيث تقول في نص (شروقٌ آفل): «تجلّت بي القيامةُ منذُ كانتْ دموع الأنبياءِ تهزُّ مهدي أنا وجعُ السماءِ وألفُ جُرحٍ تناسل في خُطى الآتينَ بعدي» «تجلّت بي القيامة» تتجسد القيامة التي هي حدث كوني في ذاتها، فتصبح مرآة للبعث والدهشة، والرعب، ويصبح الألم ذا قيمة وليس مجرد شعور عابر، «أنا وجع السماء» تربط وجعها بما هو سماويّ (أزلي)، أمّا «دموع الأنبياء تهز مهدي» فهي تمزج رمز الطفولة (المهد) بدموع الأنبياء (النبوّة) وكأن الأنبياء جميعًا يشاركون في لحظة ميلادها حيث الروحانية والقداسة. ولا تستثني الشاعرة الحب من هذه اللحظات المقدّسة، فالحب لهُ صلاته الخاصة وطقوسه الشعورية التي تفيض وجدًا ونورًا، ففي نص: (ألف نبي لقلب واحد) تقول: «أجِّل جمالكِ حتّى لحظة التعميد حتّى أغرق في مائِكَ حدَّ الغفران الأبدي حدّ الخلاص المُمتد من لحظةِ عناقٍ للحظةِ عناقٍ للحظةِ عناق..» هكذا يتحوّل الحب إلى فعل مُقدّس مثل «التعميد» فيبلغ مرتبة الحب الشعوري والروحي العميق، حيث تطلب الشاعرة تأجيل الجمال حتّى تصل إلى اللحظة التي يكون فيها اللقاء تطهيرًا، فتكون العاطفة هنا مسعىً للنقاء والخلاص في لحظةِ اتّحادٍ مُطلق، وتكرّرت «من لحظة عناق للحظة عناق للحظة عناق» إيقاعًا موسيقيًّا كترديد أو ترنيمة تشبه الصلاة، فاللحظة العاطفية هنا تصبح فعل عبادة. -الصراع بين الخلق والإرادة «مشتولةٌ بحقل الرّب مقطوفةٌ من شجرةِ القُدرة آتيةٌ من (كُن) مُمتدَّةٌ بـ (فيكون)» هكذا تنسجُ الشاعرة الدبيس سيرتها الوجوديّة لذاتها وتصوّرها كبذرة إلهية نبتت في حقل الربّ، أي في فضاء المشيئة، فهي لا ترى نفسها وليدة المصادفة، بل غرسًا مُقدّسًا منبثقًا من قُدرة الخالق، لتكشف عن صلتها العميقة بالمصدر الإلهي، لكنّها في جهة أخرى تعاني غياب إرادتها الحرّة، ما يجعلها مشدودة بين التقديس الروحي لوجودها وبين الإحساس بالعجز والحرمان من الإختيار حين تقول في نصٍّ بعنوان (بَداءٌ يجهشُ أسئلته): «لم يستأذنِّي الزمان ولا المكان لم يطرقني قرع الولادة لم تقرأني هيولات التكوّن مُجرَّدةً كنتُ من الإرادة.. ولا زلت.. مخطوطةً باللوح المحفوظ.. محمولةً على عاتق المشيئة..» يتجلى هنا الإغتراب الذي تعيشه ذات الشاعرة بينَ الخلق والإرادة، الصراع الوجودي الإنساني، حيث تتدرج من العدم إلى وجودها كمعجزة كونية ثم شعورها بالمعاناة التي تفسِّر الإنتقال من الرؤية الكونية الشاملة إلى الذات الشخصية في مشهد درامي بديع وقلِق. -الأسطورة والوعي الأنثوي تبرز الأسطورة في نصوص الشاعرة بوضوحٍ وجلاء باعتبارها ذاكرة البشرية الأولى، وهي أيضًا مرآة لذاتها وليست مجرد رمزًا زخرفيًّا فقط، بل تستدعيها ككائنات حيّة تعيش داخل اللغة، تُعبِّر من خلالها عن كوامن نفسها فعندما تقول: «هكذا كنتُ أولدُ من رحمِ سيشات مُجدّدًا» فهي لا تتحدث عن ولادة جسديّة من سيشات إلهة الكتابة والحكمة، بل عن ولادة وعيها الأنثوي الخلّاق، و بهذا تجعل الشاعرة أصلها من رحم اللغة، والحكمة، والكتابة. وتندمج معها الإلهة حيث تشاركها أيضًا جميع آلامها، ورقصها فوق الحزن كفعل مقاومة جمالي، وكطريقة وحيدة للنجاة وتحرّر من المعاناة حين تقول: «سيشات تشبهني إذا غنّيتُ حبرا ورقصتُ فوق الدمع حتّى صار تبرا وأخذتُني معها لآخر بُقعةٍ بالحُزنِ حتّى آخرِ الأوجاع» أمّا ولادتها الأخرى فهي محروسة بإله البحر والمياه أوقيانوس فتصف نفسها قائلة: «مثل حورية في كنف أوقيانوس» وبما أنّها امرأة (السرطان) على حدِّ تعبيرها، وهو البرج المائي، فهي لم تغفل أن تستحضر الماء من خلال هذه الأسطورة كأصلٍ لخلقها، الماء الذي انحدرت منه وإليه تعود، حيث يحتضنها إله البحر والمياه كالحورية التي هي امتداد لذاتها الأنثوية، فتصف من خلال ذلك حالاتها الشعورية حين تقول: «الماء الذي انحدرتْ منه مولودة السرطان الماء الذي تشكّلت فيه بجميع صورها الصلبة، والسائلة، والغازيّة جليدًا حين تكتب، ماءً حين تعشق، بُخارًا حين تشتاق» التحوّل هنا بين حالات الماء السائلة، والصلبة، والغازية، يشرح تحوّل الشاعرة بين حالات الوعي، والإبداع، والعاطفة في إيقاع تصاعدي يجمع بين الفيزيائي والوجداني. كما أنّها عنونت بعض النصوص بالأسطورة مباشرةً لتكون هذه العناوين بوّابة لفهم رمزية النصوص ومضامينها العميقة مثل: «تراتيل في محراب آمور»، «لعنة أفروديت» لتكون إطارً رمزيًّا تنسج من خلاله المعنى وتضفي عليه بُعد درامي، وتغذي من خلاله البعد الفلسفي. ختامًا حزنائيل هو فضاء يذوب فيه الحزن بالقداسة، والتجربة الروحية بالوجودية، في آنٍ واحد، هو رحلة تتخطى حدود الزمان والمكان لتلامس القلب والوعي في وحدة متكاملة من الجمال والمعنى.
