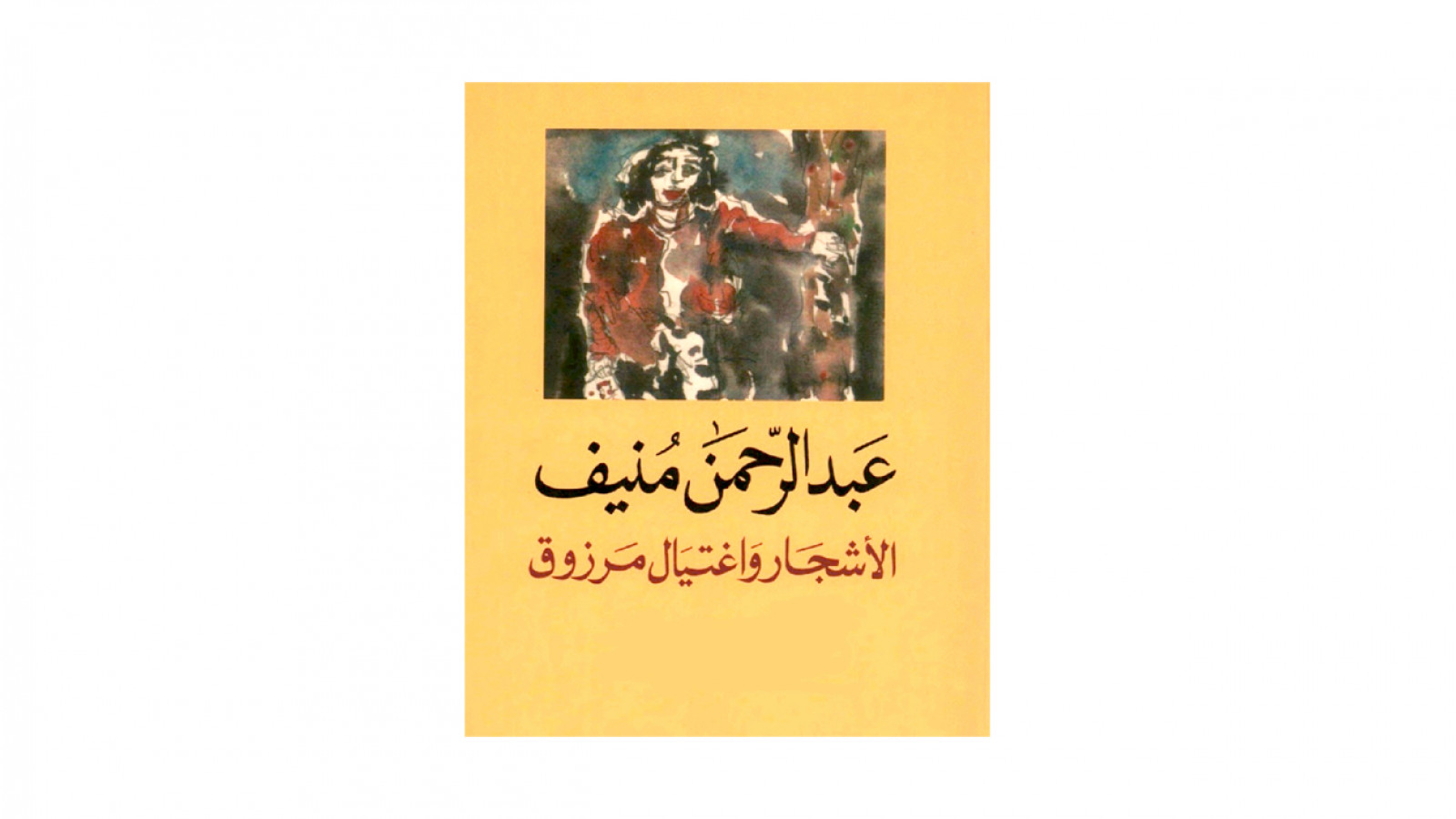
هل يبقي الأدب طازجا لأنه أدب عظيم بنفسه، أم لأنه يتحدث عن حالة إنسانية تعيش مع الناس ما عاشوا؟ إذا كانت هذه الرواية التي نتحدث عنها فربما ستعيش طويلا لأنها تتحدث عن إفساد علاقة المواطن بالوطن، الأمر الذي أصبح داءً مقيما، تقنيات المنيف هنا تدفعك للتساؤل والتأمل وأنت تبحث عن المعضلة، أقصد المأساة التي تنتزع جذور الإنسان من أرضه، فيبقى عاجزا عن أن يقيم مع وطنه علاقة أكثر من الإلتباس بين الحنين والكراهية...الاشتهاء والقرف. الحب والبغض. التوالد والقتل، ولماذا تمتد هذه الالتباسات لتُعطب علاقة الإنسان بالتراب، وبالشجر وبالحيوان.. والعلاقة هي العلاقة سواء أكان المواطن الياس نخلة المسيحي البسيط الأمي، أو منصور عبد السلام صاحب الشخصية المركبة المثقف المسلم، كلاهما علاقته بالوطن علاقة مريضة، إلياس يضيع أشجاره (الوطن) التي رعاها حتى اقترب جناها، يضيعه بالمقامرة.. ثم يفيق فيرتكب جريمة القتل وهكذا يتشتت بين المدن القائمة حول مدينته طيبة، فلا يجد عملا يجعل له في الوطن ترابا يحتويه، وحين يجد الوطن في زوجته حنة ، سرعان ما يفرقهما الموت والمرض، وحتى حين يعود إلى طيبة وإلى أرضه المعشوقة (الوطن) ليعيد التجذر فيها، يجد الناس وقد تحولوا إلى الزراعة الموسمية التي تنتهي حياة أشجارها في سنتها، وهكذا فدورة رأس المال لا معنى عندها للوطن، الوطن عندها وإنسان الوطن هما وقود الآلة ينتهيان إذا ابتلعت الآلة ما تريد منهما، المرة الأولى أضاع الياس الوطن بالمقامرة، هذه المرة يبيع إلياس أرضه ثمنا لزواج آخر، يأخذ الثمن كاهن القرية مناصفة مع أهل الزوجة. وهكذا فمحاولة الالتحام بالوطن لا تنجح ثم تباع الارض لصالح مشروع خدمي لا ينجح، ويعود إلياس إلى الترحال بحثا عن لقمة عيش يتقاسمها زورا مع حراس الحدود بين أرجاء الوطن. منصور عبد الهادي أستاذ التاريخ الذي تيتم مبكرا بهجرة والده النهائية إلى الهند. تفتح على العمل السياسي مبكرا...ثم هاجر ليتخصص في التاريخ، يكتشف كم يضم التاريخ من أكاذيب، وحين يعود أستاذا للتاريخ ويجعل هدفه البحث في تاريخ إنسان الوطن لا في التاريخ الرسمي، يجد نفسه خارج الجامعة محروما من لقمة العيش، محروما من الارتباط بامرأة تؤويه كما يؤوي الوطن مواطنه، وهكذا يعود مترجما في شركة فرنسية جاءت تنقب عن آثار الوطن، وحين حاول أن يستحث أفراد البعثة ليزرعوا الأشجار في حديقة صغيرة كحدائق بلادهم يؤكدون له انه لا علاقة لهم هنا إلا بآثار الوطن وثرواته، أما إنسانه فيكفيهم أن يعرفوا البعض بالوجوه التي لا يحتاجون لتسمية أصحابها، فالعلاقة ستنتهي بانتهاء المصلحة، والعقد معهم لم يعطهم صلاحية أن يتحدثوا مع أبناء الوطن ولا أن يشاركوهم الاحتفال بعيد العمال، ..إلى آخره. أفلح المنيف في أن يمحو صورة الوطن، فإنك تعرف أن القصة قد بدأت في فلسطين ، والقطار يشعرك أنه يمر بقرى عراقية وسورية والنخيل الذي يريد أن يزرعه يعطيك شعورا بأنك في الخليج، و الاثار و الحديث المقتضب عن النكسة يعطي الوطن نكهة مصرية .....القاص البارع يريد أن يقول إن الوطن لم يعد واضح الوجود على خريطة الكرة الأرضية، لدرجة أن مرزوق استاذ الجغرافيا قد قُتل فلم يلتفت له أحد...فما فائدة الجغرافيا إذا كنا لا نريد أن نعرف مكانا لنا علي خريطة العالم، أما أستاذ التاريخ فيغرق في الخمر و يتحول العرق إلى بول الكلاب في فمه، أصبح مثقفا عدميا يفتقر إلى اليقين، فيفقد البوصلة ثم يطلق النار على صورته في المرآة فيموت. وهنا يخلو مكانه للصحفي الانتهازي المحبوب الذي يعرف تاريخ الخيول المتسابقة وعارضات الأزياء، صحفي المرحلة، مثقفٌ عدميٌ آخر. لا أدري هل يبكينا منيف على أنفسنا أم يبكينا على بعض أوطاننا...أم على أحلام عشناها فوجدنا أقرب الناس يتنكرون لها ولنا. هذه هي قراءتي الثانية للرواية، بين القراءتين مضى ثلثا العمر، في المرة الأولى رأيتها مملة غامضة، أما في قراءتي الثانية فلم يكف سطر فيها عن أن يضرب رأسي بمطارقه حتى أزيد أرقا على أرق، رحم الله المنيف، العمر يؤذن بإنتهاء ولم يتغير من الحال إلا القليل، اللهم الا اننا يوم صدرت الرواية عام ١٩٧٣ كان أغلبنا يحلمون بوطن أجمل، اليوم كثيرون في بعض أوطاننا يحلمون بمهاجر أكثر أمانا للجيل القادم ، دمعة حرى!
